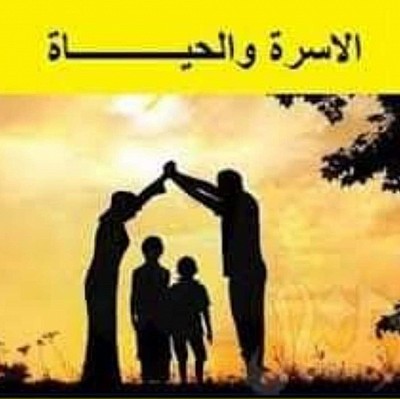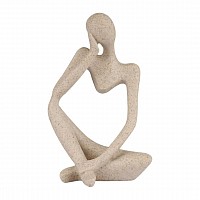مقالات اجتماعية و فكرية
المجتمع و الفرد في الإسلام
معنى الإسلام بكل اختصار هو الاستسلام لله بالتوحيد و الانقياد له تعالى بالطاعات . و لتسهيل أمر الانقياد لله بالطاعات حرص الإسلام أشد الحرص على حفظ المجتمع أولا ، فبحفظه تسهل الطاعة و بتتليفه تسهل المعصية .
أراد الله سبحانه ( الإرادة الشرعية ) أن نعيش في مجتمعات تحافظ على الفطرة ، تمدح الصالحات و تذم الطالحات من الأمور ، و لا يُجهر فيها بالفواحش ، ثم عند الذنب الذي نحن واقعون فيه لامحالة ( و نختلف في نوعية الآثام و عددها ، فالشقي منا من يأتي الكبائر و الفواحش ، و السعيد الذي إذا زل يزل في اللمم ، و بين المنزلتين منازل ) نأتي بعبادة التوبة و الإنابة و الاستغفار مع لزوم الستر ضرورة .
و جاء هذا المعنى (ضرورة سقوط الإنسان في الذنب + وجوب ستر الذنب و عدم الدعوة إليه ) متواترا في الكثير من الآيات و الأحاديث ك ؛ آية ( الذي يجتنبون كبائر الاثم... ) و ( إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض... ) و حديث كل ابن آدم خطاء... و كل أمتي معافى إلا المجاهرين... و من سن في الإسلام سنة... و من ستر مسلما ستره الله...
و أحببت أن أستدل لهذا الأمر من طريق قل الاستدلال به عليه ، و هو طريق الحدود الشرعية .
معلوم أن الله تعالى جعل حد الزنا لغير المحصن مئة جلدة ، و للمحصن الرجم حتى الموت ، لكن هنا المفاجأة ؛ ليس لكل من زنا ، إنما الحد على من زنا و افتُضح أمره .
لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قاله له لقد زنيت يا رسول الله ، فجعل النبي عليه الصلاة و السلام يُعرض عنه ، ثم يعيدها الرجل ثم يعرض عنه صلوات ربي و سلامه عليه . فإعراض الرسول صلى الله عليه و سلم عن الرجل دليل على عدم وجوب إقامة الحد عليه ، و ذلك لعدم تحقق علة الافتضاح ، فأراده النبي صلى الله عليه و سلم أن يستر نفسه و يتوب إلى الله دون إقامة للحد .
قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (4) و قال سبحانه ﴿ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾[ سورة النور: 13]
و الآيات الأُول من سورة النور عموما تؤصل لمسألة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالافتضاح أو الدليل القطعي ، فإن لم تثبت إدانته فقد رُزق البراءة الإسلامية في الدنيا ، و الحساب أُجّل إلى يوم القيامة إن كان قد أتى الذنب فعلا ، و عليه بالتوبة النصوح .
نفترض أن رجلا رأى الزنا بأم عينه و ذهب إلى دار القضاء الإسلامية للإخبار عليهما ، فما حكم ذلك !؟ حكمه جلد الرجل ثمانين جلدة و رميه بالفسق و عدم قبول شهادته أبدا إلاّ أن يتوب و هو عند الله كاذب .
اِستثني إن كان الرجل هو الزوج و ذلك لمكانة زوجته منه فهو الوحيد الذي يجوز له التبليغ بزوجته إن أصابت الزنا قال تعالى : {الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)
قد يستغرب البعض الحكم الرباني المتمثل في الجلد و تبعاته في هذا الرجل المبلغ عن الزنا ( غير الزوج ) ، ذلك لأن كثيرا من الناس لا يستحضرون مسألة وجوب الستر و حرمة الفضح ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته ، حتى يفضحه بها في بيته) رواه ابن ماجه وصححه الألباني . و كشف العورة و الفضح هنا جاءا وعيدا لمن فضح مسلما ، و معلوم عند الأصوليين أن النهي التشريعي المصاحب للوعيد يدل على التحريم قطعا ، و بالتالي فإن الستر على المسلم واجب شرعي و ليس من باب الاستحباب .
و الآن نصل إلى بيت القصيد المرتبط بعنوان المقال و المستخلص مما سبق ؛
إن الذنب المستور مرتبط بصاحبه و مضر به و لا ارتباط له بالمجتمع ، و بالتالي كان الدواء هو التوبة و الندم ، و لا يحل لمسلم أن يفضح ما سُتر من ذنب أخيه ، و إنما الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في السر هو المطلوب . و من تجرأ و فضح ما سُتر من ذنب فإن العقاب يكون على الفاضح لأنه يحاول أن يجعل من المسألة الفردية مسألة اجتماعية و هذا هو المحظور الأعظم ، و بالتالي نضحي بمصداقية الفرد من أجل حفظ المجتمع .
أما إذا تحول الذنب إلى مسألة مجتمعية بالافتضاح أو الدليل القطعي فإننا نضحي بالفرد مرة أخرى بإقامة الحد الشرعي من أجل حفظ المجتمع من انتشار الرذيلة ، و يكون الحد الشرعي تطهيرا لمن أُقيم عليه من ذلك الذنب .
فالحد الشرعي شُرع أساسا لحفظ المجتمع و ليس انتقاما ربانيا من المذنب أبدا .
و لهذا كان ذنب الجهر بالمعصية أعظم من إصابتها ، لأن إصابة المعصية مع الستر مسألة فردية أما الجهر بها فيحولها إلى مسألة مجتمعية .
و منه فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على المجتمع و على الفرد ، أما إن حصل التعارض فيكون حفظ المجتمع أولى من حفظ الفرد ، و ليعلم من يجهر بالفساد في مجتمعنا أن العاقبة نار وقودها الناس و الحجارة و العياذ بالله .
أرجو ألا يختلط الأمر علينا بين وجوب الستر و وجوب الإتيان بالشهادة ، فالستر يكون في الذنب الفردي الذي لا يُضَرُّ به الغير ، أما الإتيان بالشهادة فيكون في الذنب الذي يضر به الغير كالسرقة و القتل و...
و أخيرا فلنجلعل الآية 12 من سورة النور منهجا لنا في الحياة ﴿ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾[ سورة النور: 12] .
مهارة الحياة
أقصد بمهارة الحياة الأساليب المعاملاتية و الأخلاق الحميدة و التهاذيب النفسية التي من شأنها أن ترتقي بجودة حياتي و حياتك معنويا و ماديا ، و كلها مستخرجة و مستنبطة من النصوص الشرعية الإسلامية .
- الابتسامة ، بها تستطيع أن تحصر مجال رد فعل الآخر في الردود المحترمة دون غيرها عند معظم الناس .
- تجاهل ( تظاهر بجهل ) فضيحة الآخر المتعلقة به و التي لا تمس غيره و سترها ، بها تستطيع أن تعيد للآخر ثقته بنفسه و فرصة إعادة مراجعتها بدل انكسارها و إذلالها ، وتحظى باحترام منه و تقدير .
- النجاح هو حسن استغلال المُتاح ، النجاح يختلف باختلاف الناس و أحوالهم ، فلا تنظر لنجاح غيرك و تحاول تقليده ، لكن إنجح من خلال ما أُتيح لك ( قدراتك ، ميولاتك ، ظروفك ) هناك تجد النجاح بعد التوكل على الله تعالى .
- اللعب الجادُّ ، اعتبر الحياة لعبة جدية ، لا هزلٌ مطلق و لا جديةٌ مطلقة ، إنما هو بذل مجهود معقلن محترم للكسب في لعبة الحياة ، النتيجة ؛ عدم الفرح المفرط المفضي للغرور عند النجاح ، و عدم الانكسار و الانهزام و الاكتآب عند فشلٍ في اللعبة .
- الابتداء بالمعروف اتجاه الآخر ؛ من سبق بالإحسان و الاحترام إلى الآخر فلينتظر منه الإحسان و الاحترام ، و بممارسة ذلك مع المحيط كله تحظى بهما في حياتك و إن كنت تعيش بين اللئام
- لا تكثرت للمدح كثيرا ، و دقق جيدا في النقد المعقول الموجه لك ، فالمدح لا يعطيك إضافة واقعية ، أما النقد المعقول فهو من أنذر و أهم وسائل تطوير الذات ، تجب الاستفادة منه بشكل جيد جدا خصوصا إذا كان من أهل الحكمة أو العلم أو الخبرة ، طبعا إذا كان النقد معقولا .
- كن نحلة علمية ، كل المجالس تحتوي أشخاصا متخصصين في مجالات مختلفة ، خذ منهم حين مجالستهم معلومات في تخصصاتهم ( علم ، تجارب ، عمل ... ) بطريقة سلسة مرحة ، كل ذلك يفيدك ، و لا تبخل عليهم بما خصك الله به .
- ارحم الصغير و الضعيف و الجاهل ، و وَقِّر الكبير و العالم ، و احترم قرين السن و قرين العمل و قرين العلم .
من رحمة الصنف الأول مدح حسناته الصغيرة فيسعد و يبادر و يحسن ، و عدم الالتفات لسيئاته تجاهك لمعرفتك بحاله ، مع لزوم التواضع . هذا يزيدك احتراما
من توقير الصنف الثاني التواضع عنده و الإنصات و السؤال المهذب ، فإنك أنت المستفيد من علمه أو خبرته و تجربته ، فلا تضيع الفرصة . اشكره لإحسانه ، و لاحظ عليه بأدب حين الخطإ أو الإساءة .
من احترام القرين عدم التعالي عليه و استحضار جانب التكامل الذي يجمعك معه ، فإنك تستفيد منه و يستفيد منك فتطوران بعضبكما البعض . اشكره لإحسانه ، و بين له إساءته بمصطلحات محترمة و دقيقة إن شئت تبيانها و إلا فالصفح و التغافل أحسن .
- كن على طبيعتك و تلقائيتك ما استطعت ، و ليكن ظاهرك كباطنك و سريرتك ما استطعت ، و ليكن عملك موافقا لعقيدتك ما استطعت ، و لتكن مبادئك ثابتة ما دمت مقتنعا بها ، فإن هذا تَسهل به حياتك كثيرا و تكسب به احترام و تقدير الآخرين .
- و أخيرا فلنتمسك بدين الله تعالى كله ، فإن جميع سبل الحياة الطيبة تنبع منه .
الشعوب و القبائل
سبق لملك المغرب السابق الحسن الثاني رحمه الله و غفر له أن تحدث عن تونس و عن أهلها و قال بأن تونس يستحيل زعزعتها و إن عرف نظامها ما عرف من الثورات لكونها "شعب" ، و صدق .
إن المجتمعات البشرية تنقسم إلى نوعين أساسيين هما : الشعب و القبيلة ، قال سبحانه ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) .
لكي نفهم هذين النوعين جيدا ينبغي علينا أن نرجع بالزمن إلى ما قبل دول الحدود المصنوعة من طرف أروبا المتغلبة في الحربين العالميتين . فالعالم آنذاك كان ينقسم اجتماعيا إلى شعوب و قبائل ، ولن نبالي بالتقسيم السياسي ( أمبراطوريات ، دول ، إمارات ) لأن موضوع المقال اجتماعي بالأساس .
فالشعب هو مجتمع كبير يعيش بمدن متقاربة و بوادي بين تلك المدن ، و يشترك أفراده في الهوية و الانتماء و البيعة المركزية الحقيقة ، و من مظاهره الحضارة المادية ( العمرانية ، الصناعية ... ) ، و هو نتيجة طفرة دينية أو سياسية أو عسكرية قوية حولت مجموعة من القبائل إلى شعب واحد متحد مع مرور الزمن .
و بين كل شعب و آخر جغرافيا نجد قبائل متفرقة كبيرة كانت أو صغيرة ذات انتماءات و بيعات قبلية مستقلة عن بعضها البعض ، و بعيدة كل البعد عن المظاهر الحضارية المادية ، و أقصى ما عرفت من اتحاد هو بيعة رمزية لدولة أو إمارة أو إمبراطورية مع لزوم قانون القبيلة ، كما أن المظاهر الحضارية العمرانية القليلة التي قد نجد بها تكون من آثار الكيان المسيطر الخارجي لا من إنتاجها .
نتحدث عن شمال إفريقيا كمثال ؛ فأول شعب ظهر في هذه البقعة الجغرافية هو الشعب المصري الأول ( مصر الفراعنة ) و لعل العامل الجغرافي ( نهر النيل ) كان هو الأساس في تطور تلك القبائل إلى شعب ثم إلى حضارة . ثم بعد زمن ظهر الشعب التونسي بفعل العوامل السياسية ( الدولة القرطاجية ) و كانت الاستمرارية إلى أفريقية و القيروان مع الإسلام . ثم ظهر الشعب المغربي بفعل عوامل دينية سياسية كانت بذرتها الدولة الإدريسية ثم نضج الشعب مع استمرار الحكم الملكي المركزي الذي دام إثنى عشر قرنا من الزمن كثاني أقدم ملكية بالعالم ، و للإشارة فالأندلس هي تفاعل هذا الشعب مع البيئة الإيبيرية . و رغم أن الشعبين المصري و التونسي عرفا فراغا سياسيا بعدم استقلاليتهما السياسية في كثير من المراحل التاريخية إلا أن هوية الشعب استمرت فيهما .
بينما لم تعرف الأراضي بين هذه الشعوب التطور من القبيلة إلى الشعب ، و أقصد ما يسمى اليوم بالجزائر و ليبيا ، حيث أنها لزمت الشكل المجتمعي القبلي ، و "القبايل" الجزائرية الأمازيغية من البراهين الظاهرة المبينة لهذا الطرح ، فهاتين الدولتين وليدتي التقسيم المزعوم ، و لم تبدأ بذور تطور أهلها من المجتمع القبلي إلى مجتمع الشعب إلا بعد الاستقلال من الاحتلال الأروبي . و هذا ما قصد ملك البلاد الراحل بكلامه .
و أشير هنا إلى حملة الاستيلاء الثقافي العنيفة التي تمارسها دولة الجزائر على دولة المغرب حاليا ، فذلك نتيجة للفراغ الحضاري التاريخي الذي تفاجأت به دولة الجزائر بعد استقلالها ، خلاف الحضارة المغربية أو التونسية المادية الثابتة بالعمران و الصناعة التقليدية .
أخيرا فتشكل مجتمع على شكل شعب أو قبيلة ليس تكريما كما قال الله سبحانه و تعالى ، و إنما الأكرم بالتقوى ، فهذا هو المعيار الحقيقي الإلهي ، ثم القصد من اختلافنا هو التعارف فيما بيننا كما قال عز و جل ، فإذا لم نتعارف فإننا نخالف الإرادة الكونية لله سبحانه و بالتالي تكون النتيجة هي التخلف بدل التقدم ، و الحدود المغلوقة بين المغاربة و الجزائرين الآن تحول دون التقدم لزاما . ثم إذا سألتكم ؛ من أقوى الدول و أكثرها تقدما ماديا و علميا ( العلوم التجريبية ) ؟ فلن نختلف على أنها الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم أشير إلى أن هذه الدولة عرفت أكبر تعارف و تجانس بين أفراد شعوب مختلفة في أرض واحدة ! لعل هذا سببا أساسيا في بروز هذا الكيان القوي .
انسجام الزوجين
أهم أسباب فساد المجتمع يتمثل في مصيبة كثرة التفككات الأسرية ، و علم ابليس هذا قبل أن يعلمه عموم البشر ، فكان و لازال يحب انفصال الزوجين و يفضله عن وقوعهما في كبيرة من كبائر المعاصي ، وهذا لعلة واضحة بينة و هو أن الطلاق و إن كان حلالا فهو دافع كبير للوقوع في جميع أنواع المحرمات ، سواء من طرف الرجل أو المرأة أو الأبناء ، و بالتالي ظهور التشوهات المجتمعية ففساد المجتمع .
لكن يحز في نفسي أن أغلب الانفصالات تكون لأسباب تافهة أو مجهولة و غير واضحة عند الطليقين قبل غيرهما ، و تكثر هذه الظاهرة عند المتزوجين الجدد ( أقل من خمس سنوات ) فيتضرر الطليقان نفسيا و ماديا و اجتماعيا فيضعف انتاجهما الإيجابي في جميع مناحي الحياة قبل أن يستدرك كل منهما نفسه مع اختلاف مدة التيه عند كل فرد حسب شخصيته و مؤهلاته ، و قد تدوم مدة التيه عند البعض إلى الممات ، فإما خسارة مطلقة أو جزئية للفرد و للمجتمع ككل .
لكن طلاق اللاسبب هذا إنما هو ناتج في 90 % من الحالات عن عدم ادراك الزوجين لمسألة مهمة جدا و هي أن كل واحد منهما ابن بيئة مختلفة عن بيئة الآخر ، و بالتالي فإن ما يعتبره أحدهم مرفوضا قد يراه الطرف الآخر مطلوبا لاختلاف المشارب الأسرية ، و يجب على الزوجين أن يدركا أن الأسرة التي هم مقبلون على بنائها تختلف عن كل أسرة في محيطهما ، فلا يحاول الرجل نسخ أسرته الصغيرة على شاكلة أسرته الأصلية التي تفرع منها أو على شاكلة أي أسرة أخرى ، و كذا بالنسبة للزوجة ، فلا ينتظر الرجل أن يجد زوجته كأمه و لا تنتظر المرأة أن تجد زوجها كأبيها فهذا من المحال ، إلا أن يتعلما من بعض الأسر المثالية أشياء نسبية تتمتشى مع وضعيتهما .
و يلزم من هذا بناء الأسرة الجديدة على أسس و قواعد جديدة تلائم الطرفين معا ، و لابد وجوبا و لزاما و ضرورة التنازل عن بعض القناعات غير المبررة شرعا بين الطرفين ، كما يلزم أيضا الثبات على القناعات المبررة و الخطوط الحمراء و توضيحها بين الطرفين أول الأمر و باستمرار لأنها أساس ذلك التعاقد .
و أركز على تنازل الطرفين لبعضهما البعض في غير الثوابت و الخطوط الحمراء، لأن التنازل يؤدي إلى الاستقرار و عدم التنازل ينتج الانفصال الحقيقي أو النفسي ، و هذا ما ينبغي على الزوجين تفعيله في الخمس سنوات الأولى .
أمثل لذلك بدمج عجين أزرق بآخر أصفر ، فإن هذا العجين سيبدو في أول الأمر غير متجانس ، و قد يظن صاحب العجين أنه أخطأ التركيبة فيرمي كل شيء و هذا ما يحصل للأسف في حالات كثيرة ، بينما لو صبر على ذلك فإن هذا العجين سيتجانس و يصبح أخضرا ، و هذا هو المطلوب ، و لهذا تجد المتزوجين قديما يتصفون بصفات متشابهة شيئا ما بخلاف صفات منبعيهما ، فيصير الرجل أقرب إلى زوجته صفة من أخيه الذي تلقى معه نفس التربية و المبادئ .
فالصبر الصبر و التنازل و المودة و الرحمة لتحقيق الاستقرار و النجاح الأسري و الله المعين .
صناعة الفكرة و المفكر
الفكر حقيقة غير ملموسة يُنتج آثارا ملموسة أحيانا و غير ملموسة أحيانا أخرى ، و يُجمع العقلاء على حتمية كينونته . قال رب العالمين ﴿ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾[ سبأ: 46] فاعتبر الله عز و جل التفكّر المبني على الفكر و جعله معتمدا في باب الإيمان ، و هو أهم مجالات الإنسان في الدنيا على الإطلاق . و قال ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود ، فاستدل على الوجود بالتفكير ، أي أنه يؤمن بالتفكير أكثر من إيمانه بوجوده في الدنيا ، و اعتمد الغرب مقولته ثم اعتمدتها الحضارات المعاصرة كلها .
و منه يظهر أن الأمم الإنسانية في مشارق الأرض و مغاربها تقر بكينونته على اختلافٍ في ماهيته ، و الإشكالية التي يحاول المقال معالجتها اليوم هي ؛ كيف نطور ملكة التفكير و آلية الفكر ؟
يصعب على الكثير التعامل مع ما هو مجرد ، و لا يصعب عليهم التعامل مع ما هو ملموس مادي ، و لهذا سيستند هذا المقال على القياس برياضة كمال الأجسام في شرحه لسبل تطوير ملكة التفكير حتى تعم الفائدة .
نعلم أن الدماغ هو العضو المسؤول عن التفكير ، و أن العضلة هي العضو المسؤول عن حمل الأثقال لبناء الجسم . و أنهما يتطوران إيجابا و سلبا ، و يتقويان بكثرة الاستعمال غير المفضي للإنهاك ، و يضعفان بقلة الاستعمال و الكسل ، و هذه حقيقة عضلية شهدت التجربة على صحتها ، و هي أيضا حقيقة دماغية شهدت المشاهدات الحياتية على صحتها ، فهذا رجل يتعجب من دقة و قوة بحثه العلمي أثناء دراسته ، حيث ساهم أمر توظيفه في وظيفة معينة في كسلٍ أصاب دماغه و تراجعٍ ملحوظ في إمكانياته الفكرية بسبب لزوم العمليات المتكررة المطلوبة منه في العمل دون غيرها من الأعمال الذهنية التي تطور ملكته الفكرية أو على الأقل تحافظ على قدراته المكتسبة سلفا . و تجد آخر في نفس سنه مفكرا جيدا رغم محدودية شهادته العلمية و الفرق الشاسع بين شهادتيهما ، وهذا في الحقيقة لا يكون راجعا إلى ظلم أثناء الدراسة إلا نادرا جدا ، و إنما يكون في أغلب الأحيان رجعا إلى كون الثاني نهج في حياته بعد شهادته نهجا يعتمد إعمال الفكر و النظر ، مما جعل ملكته الفكرية تتطور رويدا رويدا ، في حين تتدهور ملكة الآخر رويدا رويدا بسبب إحساس الوصول إلى المنصب و عدم وجود الداعي للتطور ، فتكون النتيجة ما سلف .
كما أشير إلى أن الأمر غير متكافئ في بدايته ، حيث تأثر الجينات و الظروف المعاشة سابقا و الأحداث في تفوق طفل على آخر في عملية الفكر ، كما يتفوق شاب على آخر في بداية بناء الجسم ، حيث تجد لأحدهما جسما يملك مقومات التطور أكثر من جسم الآخر ، إلا أن أمر الرغبة و الاجتهاد حاسم أكثر في سباق كمال الأجسام ، فصاحب الجسم الأنحف عند الانطلاق إن تمرن بجد أكثر من صاحبه فلا محالة أنه سيتجاوزه يوما ما ، أما إن اعتزل صاحبه فسيكون الفرق أعظم لصالح المستمر رغم الإمكانيات البدئية الكبيرة للمعتزل . و هكذا أمر الدماغ تماما .
و تطوير الفكر يعتمد على ثلاثة أسس هي :
-الآلية المنطقية ؛ و هي أدوات بناء الفكرة ، و يمكن اكتساب هذه الآلية بطرق مختلفة ، إما بدراسة علم المنطق و هو الآلية المباشرة ، أو بدراسة علوم أخرى تعتمد المنطق في بنائها مثل علم أصول الفقه أو الرياضيات (إن استطاع دارسه ربط مجرد الرياضيات بمادية الدنيا) و هي آليات غير مباشرة . و المنطق بالنسبة لبناء الفكر كالآلات الرياضية لبناء الجسم .
-المعارف و الحقائق و تنوعها ؛ و هي الأسس و المادة الخام التي تستعملها آلية المنطق لبناء الفكر ، كما تستعمل آلات البناء الآجور لبناء المبنى ، فلن تستطيع استخلاص أي نتيجة دون وضعيات و معطيات أولية صحيحة ، فإن قلتُ لعالمِ رياضيات استخلص قيمة x دون أن أمده بمعطيات قبلية فلن يتمكن من استعمال منطقه المجرد (الرياضيات) للوصول للحل ، ولابد له من معادلة أولية ينطلق منها . و يمكن اعتبار أن المعارف الأولية لبناء الفكر كمعرفة كيفية استعمال آلات كمال الأجسام ، فلن أصل إلى نتيجة و أنا أبني عضلة الفخذ بآلة بناء عضلة الصدر ، و سأُنتج جسما مشوها كما ينتج المفكر الفاقد للمعطيات الأولية فكرا باطلا و مشوها .
-التفكير : و هو ممارسة الفكر بالمنطق انطلاقا من حقيقةٍ أو صوابٍ و وضعيات مختلفة ، و هذا يمهد طرق الإشارات العصبية بالدماغ و يجعل عملية التفكير أسرع و أجود و هو عين تطوير الفكر ، و التفكير لبناء الفكر كالتمرين لبناء العضلة ، كلما كان بجد و اجتهاد و ديمومة كلما أعطى نتائج محمودة ، بشرط عدم الإفراط المفضي لاستنزاف العضو و هلاكه ، و الكسل أو الحبس يؤدي إلى إضعاف العضو . و للشيخوخة نفس التأثير على العضوين مع فارق شيخوخة العضلة قبل شيخوخة الدماغ عادة .
أخيرا أشير إلى أنني ألاحظ إقبال الشباب على بناء الجسم و إدبارهم عن بناء الفكر ، و لا شك أن لهذا الأمر عواقب وخيمة مستقبلا أهمها الاعتناء بكل ما هو ظاهر ملموس و إهمال كل ما هو باطن محسوس .
التوتة و الطرطة (الطّماعة)
الإنسان و نهجه العام نتاج تفاعل عوامل ثلاثة ، رابعها الهداية الربانية ، وهذه غيبية لا سبيل لعقل الشهادة إليها .
أما الأولى فالوراثة ؛ وهي ما قدر الله للإنسان من صفات خِلقية عموما و من استعدادات جينية للتفاعل مع الغير بطرق معينة خصوصا .
و الثانية هي البيئة و المحيط ؛ وهي ما يترعرع فيه الإنسان منذ صغره و يكتسب منه الضوابط و الأعراف و كثير من القيم .
ثم الثالثة و هي الظروف ؛ و هي الأحداث التي مر منها الفرد خصوصا دون محيطه و تأثيرها عليه سواء بالسلب أو الإيجاب .
فتكون النتيجة النهائية ؛ شخص بقناعات فأفكار فأخلاق فسلوكات معينة مختلفة في مجملها عن بقية البشر كما تختلف بصمة الأصبع و البؤبؤ ، و إن تشابهت بعض جزئياتها مع بعض جزئيات الاخرين .
بالتالي مجتمع بأصناف عديدة من الناس مختلفين في شتى المجالات رغم ما يجمعهم من بيئة و محيط. ولا نريد اليوم من الاختلافات إلا واحدا ؛ باب الطمع و القناعة (الطّماعة) .
بدأت بالطمع لأنه من الغريزة السابقة ( و ما يملأ جوف ابن ادم إلا التراب ) ، و أنهيت بالقناعة لأنها من المبادئ اللاحقة ؛ فالطمع نكتسبه مع أول خروج للدنيا ، و القناعة لا نكتسبها إلا بعد رشد و تهذيب للنفس ، منا من يُحصلها فيرتقي إنسانا ، و منا من يُحرمها فيضل بشرا.
والناس من حيث "الطّماعة" أصناف عديدة ، و هم أصناف الطرطة و التوتة ؛ و المقصود هنا ثمانية أشخاص مشتركون في طرطة دائرية تتوسطها توتة حمراء جذابة يريدون قسمتها بينهم ، و كل شخص من الثمانية في الوضعية الافتراضية يمثل صنفا من أصناف المجتمع في هذا الباب.
الأول القنوع: وهو الذي أخذ حقه (الثمن) من الطرطة كحق مشروع له و ترك التوتة يفعل بها الاخرون ما شاءوا لاستحالة قسمتها على ثمانية.
الثاني الطماع: وهو الذي يريد حقه من الطرطة بالإضافة إلى التوتة لاستحالة قسمتها بين الثمانية ، و أطمع منه الذي يريد أخذ أكثر من حقه من الطرطة نفسها ، و أطمع منه من يريد أكثر من حقه في الطرطة و أيضا يريد التوتة لنفسه.
الثالث الزاهد: وهو الذي يزهد في الطرطة و التوتة و يتركهما معا للآخرين.
الرابع الأناني: وهو الذي يرد التوتة و الطرطة كلها له وحده وهو شر من الطماع ، فالطماع يريد ما يعلم أنه ليس له ، بينما الأناني يريد ما أقنع نفسه أنه هو الأحق به من غيره بغير وجه حق.
الخامس المفاوض: وهو الذي يفاوض للتنازل عن التوتة مقابل زيادة في الطرطة ، أو يفاوض للتنازل عن جزء من الطرطة مقابل الفوز بالتوتة.
السادس العنيد: وهو الذي يُطالب بقسمة التوتة على ثمانية رغم استحالة ذلك كما تُقسم الطرطة.
السابع الغيور: وهو المستعد للتنازل عن التوتة بشرط عدم استفادة أي من الاخرين منها ، مع أخذه لحقه من الطرطة.
الثامن المتفرد: وهو الذي يتنازل عن حقه في الطرطة كاملا مقابل فوزه بالتوتة ، رغم أن قيمة حقه في الطرطة أفضل و أثمن من التوتة نفسها ، لكن حبه للتفرد و الاختلاف أو الشهرة جعله يتنازل عن الأثمن مقابل الأندر.
لابد أن نجد أنفسنا في وضعيات "الطّماعة" يوميا ، و تختلف الوضعيات كما تختلف زوايا التموقع فيها ، فهناك وضعيات لا تحتمل أكثر من صنفين من هذه الثمانية ، و أخرى لا تحتمل أكثر من أربعة ، لكنها لن تخرج في عمومها عن هذه الثمانية المذكورة .
كما ينبغي استيعاب أن تموقع الفرد يختلف أحيانا من وضعية إلى أخرى وذلك لاعتبارات منها مدى جاذبية الوضعية للفرد و مدى أهميتها عنده و كذلك حالته الخاصة حين تشكل الوضعية . لكن المؤكد هو أن لكل فرد تموقعا أو تموقعان أو ثلاثة في أقصى تقدير يرتاد عليهما كثيرا ، و هاته تبرز كنهه و جودة إنسانيته.
المفكر
المفكر هو كل صاحب عقل يفكر به في أمور الفكر قياسا على الرياضي الذي هو كل صاحب جسد يتريض به في أمور الرياضة ، وكما أن الحركة خارج ما اصطلح عليه بالرياضة لا تعد رياضة ؛ فإن التفكير خارج ما اصطلح عليه بالفكر لا يعد فكرا . فما هو الفكر ؟ وما أهدافه ؟
الفكر هو إعمال العقل الراجح في الحقائق و استخلاص النتائج الفكرية ، وهو أنواع مختلفة يمكن حصرها في ثلاثة جامعة و هي كالتالي :
-استشراف المستقبل و توجيه المجتمع : الفكر قادر على استشراف المستقبل المرتبط بظواهر و حقائق مجتمعية مما يجعله موجها مهما للخطوات المجتمعية و السياسية المستقبلية و كذلك للخطوات العلمية الاجتماعية باعتبار الأصول العقلية للمفكر ، علما أن المفكرين قد تختلف توجيهاتهم لاختلاف أصولهم و ممارساتهم العقلية . وهذا كله يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التطور و التقدم على خطى المجتمع التي اختارها العقل الجمعي مسبقا و من ضمنه المفكر . إلا أن يكون الأخير على خلاف مع العقل الجمعي فيكون نوع الفكر بالنسبة له ليس استشرافا و إنما ما سيأتي .
- تصحيح المفاهيم و الأفهام المغلوطة المسلمة عند المجتمع : الفكر قادر على تصحيح معتقدات و مفاهيم مسلمة مغلوطة عند المجتمع ، اكتُسبت بسبب هفوة ممارساتية أو هرطقية عمل بها المجتمع بطريقة ما سابقا ، كما قد تكون قد اكتُسبت من توجيه محرف عمدا لمسار العقل الجمعي ، و هذا ما أصبحت وسائل الإعلام بارعة فيه جدا .
وسواء النوع الأول أو الثاني فهما سببان مباشران لما قد يتعرض له المفكر من تهميش و عدوان أحيانا من الطبقة الحاكمة و السياسيين ، و ذلك إما بسبب استشراف يخالف أو يتعارض مع المخطط السياسي أو بسبب تصحيح فكري للوضع الراهن يخالف التوجه السياسي المعمول به .
- تفصيل المجملات : الفكر قادر على توضيح الصورة الفكرية الضبابية من خلال تفصيل المجملات و إظهار الخبايا ، مما يجعل المجتمع المعتمد على مفكريه قادرا على التفاعل مع الظاهرة أو الفكرة بطريقة أفضل تعود على مستقبل المجتمع كله بالإيجاب .
ختاما فالمجتمع الذي يعتمد على المفكرين يتطور و يتقدم في مساره بشكل سريع ، كما أنه يستطيع من خلالهم تصحيح الخطوات المغلوطة و استعادة المسار الصحيح و رؤية الأمور بشكل واضح يسمح باتخاذ قرارات أصوب و أنجح .