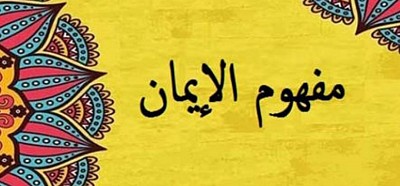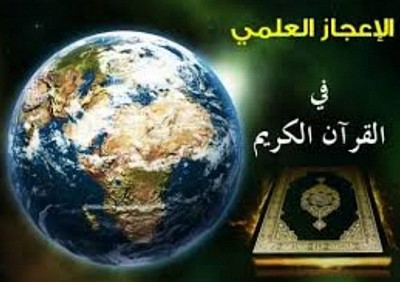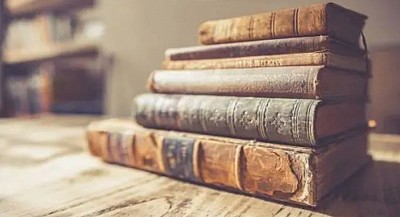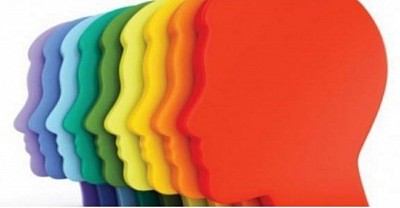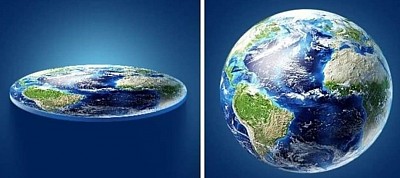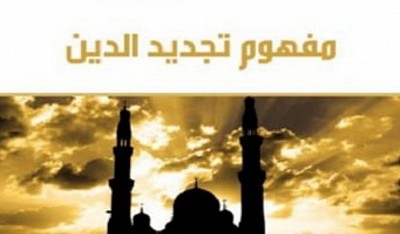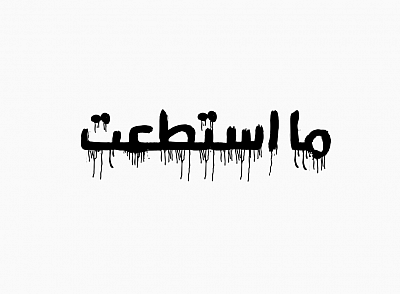مقالات إسلامية
تعريف الإيمان شرعا
الإيمان هو تصديق بالجنان ينتج منه لزوما و مباشرة أقوال باللسان و أفعال بالقلب و الجوارح تدل على التدين بالإسلام
شرح التعريف :
الإيمان هو تصديق بالجنان : أي تصديق بأركان الإيمان موضعه القلب
ينتج منه لزوما و مباشرة : أي ينتج من هذا التصديق الذي موضعه القلب ضرورة لأن التصديق دون ما ينتج منه لا يسمى و لا يصبح إيمانا و يبقى تصديقا لا يغني صاحبه كتصديق أبو طالب لرسالة النبي صلى الله عليه و سلم فإنه لم يغنه شيئا و مات من المشركين . و بشكل مباشر أي مع التصديق تظهر تلك الأقوال و الأفعال ، و نسطر تحت منه ، أي ما سينتج هو من التصديق .
أقوال باللسان : مثل لا إله إلا الله ، الله أكبر ، سبحان الله ، محمد صلى الله عليه و سلم ...
و أفعال بالقلب : مثل الخشوع ، الحياء ، حب الله و الرسول ، بغض الكفر و الشرك ...
و أفعال بالجوارح : أي أفعال بأعضاء الجسم مثل الصلاة ، الصدقة ، إماطة الأذى عن الطريق ...
تدل على التدين بالإسلام : وهو كما سبق في الأمثلة ، أي تدل عل ممارسات شرعت في الإسلام و ليس كطرق غلاة الصوفية الذين يتعبدون بغير ما شرعه الإسلام كالذكر مع القفز و الطواف حول الأضرحة و التطبيل بالطبول ...
و الله تعالى أعلى و أعلم
مغزى الإعجاز العلمي في القرآن
-لماذا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم !؟
-لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه و سلم آيات الإعجاز العلمي كما فسر آيات الاعتقاد و الفقه و غيرهما !؟
-لماذا يكتشف علماء الغرب الحقائق ثم نجدها نحن في القرآن و ليس العكس !؟
لطالما استغرب المسلم هذه الأسئلة بينه و بين نفسه ، و لعل اليوم تظهر أجوبتها إن شاء الله.
أنزل الله تعالى القرآن الكريم على خاتم الأنبياء و المرسلين صلى الله عليه و سلم في زمان كانت العرب فيه تتباها بالفصاحة و البلاغة ، فجعله الله أفصح و أبلغ من كل كلام البشر ، و جعله معجزة النبي الخاتم العظيمة و الباقية و الصالحة لكل الأزمان و الأماكن ، فآمن من آمن من العرب لما في القرآن من الفصاحة و الدعوة لمكارم الأخلاق و الدعوة للتوحيد ، ثم وجد المسلمون بعد الفتح الإسلامي و دخول الناس في دين الله أفواجا أجزاء من آيات كريمات لم تستعمل لا في أمور الفقه و لا العقيدة و لا القصص و لا الأخلاق و لا الدعوة مثل قوله سبحانه ( و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) فيقول القائل في ذاك الزمان لماذا قوله تعالى كأنما يصعد في السماء!!؟ في فهم منه أنه يكتفى بما سلف ذكره دون هذه الجملة ، حتى إن الكثير من المفسرين لم يفسروها و اكتفو بتفسير الجزء الأول منها ، وهنا في الحقيقة مظهر من أهم مظاهر المعجزة الخالدة في كتاب الله ، و ذلك لأن الله عز و جل تكلم بهذه الآية لتكون تبيانا لأناس من غير المسلمين في زمننا هذا الذي يعظم أهله العلوم التجريبية على أن القرآن هو الحق ، قال سبحانه ( سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) فهم الذين رأوا و علموا و اكتشفوا أن الصعود في السماء يؤدي إلى ضيق الصدر و التنفس لأن الضغط الخارجي يقل فيصبح الضغط الداخلي أقوى فيختل التوازن بينهما و يضيق صدر الإنسان ، و هنا خلود الإعجاز في كتاب الله ، و هنا يظهر لماذا الإعجاز العلمي في القرآن كثير، و لا يجحده إلا ذو فهم قاصر ، و قدر الله الحكيم أن يكتشف الكفار هذه الحقائق بأنفسهم ثم يجدونها مطابقة لما في القرآن فيؤمن المنصفون منهم و تقام الحجة على الجاحدين ، و لو كان المسلمون في هذه الفترة الزمنية القصيرة أصحاب العلم و الاكتشاف لما صدق جل الكفار ما اكتشفه المسلمون لتطابقه مع القرآن ، و إن كنت لااااااااا أدعو إلى التكاسل و ترك باب الاكتشاف للكفار فقط ، و الله تعالى أعلى و أعلم .
الحق و الصواب و الراجح في الشرع
* الحق هو ما ثبت بدليل أو أدلة قطعية الثبوت و الدلالة لا تعارضها أدلة أخرى قطعية أو ظنية الثبوت ، قطعية الدلالة . يوجب الاتباع و الأمر به ، و يُرمى بالضلال من نفاه ، و مقابله الباطل ، و لا يحتمل النسبية .
* الصواب هو ما ثبت بدليل أو أدلة قطعية أو ظنية الثبوت ، قطعية الدلالة تعارضها فهوم لأدلة قطعية أو ظنية الثبوت ، ظنية الدلالة ، يوجب الاتباع و الأمر به و يُرمى بالخطإ من نفاه ، و مقابله الخطأ ، و يحتمل النسبية باعتبار ما خفي من الأدلة لا باعتبار ما تحت اليد .
* الراجح هو ما رجح بدليل أو أدلة قطعية أو ظنية الثبوت ، قطعية أو ظنية الدلالة ، تعارضها فهوم لأدلة قطعية أو ظنية الثبوت ، قطعية أو ظنية الدلالة ، أضعف منها في الثبوت و الدلالة أو في واحدة منهما دون الأخرى ، يوجب الاتباع على من رجح عنده باجتهادٍ ( المجتهد ) أو بترجيحٍ بين الأقوال ( المرجح ) دون غيره ، يُنصح به و لا يؤمر ، و لا يُرمى بشيء من نفى رجحانه ، و مقابله المرجوح ، و محتمل للنسبية .
و أشير إلى أن قطعية الدلالة لا تكون دائما بدلالة اللفظ ، فقد تكون بدلالة اللزوم و يكون الدليل اللفظي ظني الدلالة .
دليل قطعي الثبوت : متواتر .
دليل ظني الثبوت : الآحاد الصحيح و الحسن .
دليل قطعي الدلالة : دلالته قطعية على ما استدل به لأجله .
دليل ظني الدلالة : دلالته غير قطعية على ما استدل به لأجله .
دلالة اللفظ : صريح في ذكر الموضوع .
دلالة اللزوم : غير صريح في ذكر الموضوع ، ملزم في الدلالة عقلا .
أصناف المسلمين من حيث التفقه في الدين
يختلف المسلمون من حيث قدراتهم العقلية الفطرية و المكتسبة اختلافا كبيرا ، مما ينتج عنه اختلاف في المسؤولية الملقاة على عاتقهم من حيث تفقههم فيما يلزمهم في أمور دنياهم و أخراهم .
نبدأ أولا بتقسيم التفقه حتى لا يختلط الحابل بالنابل .
يمكن تقسيم التفقه إلى تفقه الخاصة و تفقه العامة ؛
- فتفقه الخاصة هو تفقه طلبة العلم الشرعي الذين تخصصوا في هذا الميدان الجليل لارتباطه بشريعة الله سبحانه و تعالى ، و حكمه فرض كفاية على كل مجتمع من المسلمين ، أي إذا قام به البعض سقط عن الكل و إذا تركه الكل أثم الجميع ، و الكل هنا هو كل المجتمع لا كل الأمة كما يفهم الكثير ، و الدليل قول رب العزة و الجلال ( وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍۢ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فيجب أن تنفر من كل فرقة ( مجتمع ) من المسلمين طائفة ( مجموعة ) ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم ( مجتمعهم ) إذا عادوا إليهم لعل المجتمع يحذر من عذاب الله . في هذه الآية الكريمة تبيان على أن بعض الفتاوى التي تصلح لمجتمع في المشرق مثلا قد لا تصلح لمجتمع في المغرب و العكس صحيح ، و ذلك لأن أحوال المجتمعات مختلفة كما أحوال الأفراد مختلفة ، و أمثل لذلك بفتوى عدم جواز العمل في مكان به اختلاط و إن ساد الاحترام عند المشارقة و هذا لأن جل مجتمعهم كذلك أو كان كذلك ، و التي لا يمكن إسقاطها في مجتمع المغاربة و إلا قلنا العمل بالمدرسة العمومية حرام مثلا ، و هذا بعيد جدا عن الصواب .
و هذا التفقه يدخل تحته المتبع و المرجح و المجتهد .
- تفقه العامة و هو الواجب وجوبا عينيا على كل مسلم ، و هو التفقه في المسائل التي تهم طبيعة حياتك ، منها ما هو مشترك بين الجميع كالتفقه في الصلاة و الصيام عند البلوغ و التفقه في النكاح عند الزواج و هكذا ، و منها ما هو غير مشترك بين الجميع لأن من الأفراد من سيحتاجه في حياته و منهم من لن يحتاجه كبلوغ المال للنصاب و مرور الحول الذي يوجب التفقه في الزكاة ، و الاستطاعة المالية و الجسدية التي توجب التفقه في الحج و هكذا .
و هذا التفقه يدخل تحته المقلد و المتبع و المرجح .
فالمتبع و المرجح يدخلان في كلا القسمين ، و لكن متبع و مرجح القسم الأول يختلفان عن متبع و مرجح القسم الثاني و سيأتي تبيان ذلك في تتمة المقال إن شاء الله .
- المقلد : هو ذلك المسلم الأمي ذو القدرات العقلية الضعيفة ، و الذي أجاز له الفقهاء بعض الأذكار بدل الفاتحة في الصلاة لعدم قدرته على حفظها ، أو ذلك الرجل المسن الذي أسلم حديثا و لا يُتوقع استمرار حياته طويلا و هكذا ، و هؤلاء يجوز لهم اتباع قول أقرب فقيه منهم يثقون به دون مطالبة بالدليل الشرعي لعدم قدرتهم على فهمه .
- المتبع في تفقه الخاصة : هو ذاك المبتدئ في طلب العلم الشرعي و الذي يجب عليه تبني أقوال شيخه الذي لزمه بعد أن تحرى عن عقيدته و علمه و أدبه مع معرفة الدليل الشرعي ، و لا ينبغي له مخالفة شيخه بتبني أقوال مشايخ آخرين إلا بعد بلوغ مرحة التوسط في الطلب و القدرة على الترجيح .
- المتبع في تفقه العامة : هو ذلك المسلم العادي ذو القدرات العقلية العادية ، و تمثل شريحته أغلب المجتمع في عصرنا ، و هؤلاء ينبغي عليهم اتباع قول أقرب فقيه منهم يثقون به و بعلمه مع وجوب مطالبتهم بالدليل الشرعي الذي يعضد قوله .
- المرجح في تفقه الخاصة : هو طالب العلم الشرعي الذي بلغ مرحلة التوسط في الطلب و صار قادرا على الترجيح بين أقوال العلماء المرفوقة بالدليل الشرعي في الخلافيات ، و لا ينبغي له الخروج بقول جديد مخالف لأقوال العلماء .
- المرجح في تفقه العامة : هذه المرحلة هي منتهى فئة تفقه العامة التي لا يجوز لهم تجاوزها ، و المرجح هنا هو ذاك المسلم المتعلم الذي اكتسب في مراحل تعلمه لعلم من العلوم المستقلة عن الإسلاميات ضوابط معرفية و عقلية تجعله قادرا على الترجيح بين أقوال الفقهاء في الخلافيات بعد تتبع الأدلة .
- المجتهد : هذه المرحلة هي منتهى فئة تفقه الخاصة و يصلها العالم الذي تبحر في علم من العلوم الشرعية فيصبح قادرا على الاجتهاد في ذلك العلم الذي أتقنه و إن خرج به اجتهاده المبني على أسس علمية متينة إلى قول جديد . غير أنه لا ينبغي له الاجتهاد في العلوم الشرعية التي تخالف تخصصه إلا بعد بدل الجهد فيها كما بدل في تخصصه ، فالمحدث نقدم قوله في علم الحديث و نأخر قوله في أصول الفقه مثلا و هكذا .
و الله تعالى أعلى و أعلم
الحزبية المقيتة
- الحزبية في الإسلام هي التكتل تحت اسم ما ، له رجال و فكر و كيان معين ، و هي محرمة مذمومة نثنة و إن كان مسماها يوحي بالصلاح ، إلا حزبا واحدا ؛ و هو حزب الإسلام و المسلمين .
قال تعالى : { وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْوَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَقُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(103)وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(104)وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(105)
و قال سبحانه (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ) (54)
أدلة تحريم الحزبية كثيرة جدا ، لكنني سأكتفي بهذين الدليلين لشموليتهما .
- مفاسد الحزبية كثيرة أذكر منها :
- التكتل تحت مسمى ما لفكر و كيان معين يجعل الولاء و البراء باعتبار ذلك التكتل لا باعتبار الإسلام و الكfر ، و هو أمر عظيم التحريم عند الله .
- تكتل الصالحين أو العلماء تحت مسمى ما لفكر و كيان معين يحد كثيرا من إصلاحهم للمجتمع ، علما أن إصلاحهم في المجتمع هو الدور الرئيسي الموكل لهم مجتمعيا في الإسلام ( الدين النصيحة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر - الأخلاق الحسنة - عون المرء لأخيه المسلم - الدعوة إلى الخير - بذل المعروف... )
و الحد من الإصلاح في المجتمع عند هذه الفئة يكون لعاملين ؛ عامل داخلي يتمثل في اقتصار الحب و النصرة على أفراد الحزب فقط و الأصل هو الحب للمسلمين و النصرة لهم جميعا و بغض المحرمات و الذنوب ، و عامل خارجي يتمثل في اجتناب المسلمين لنصح و توجيه كل منتم إلى كتلة معينة بخلاف غير المنتمي فإنه يحظى بقبول كبير .
و ينبغي التفريق بين تصنيف خبراء الاجتماع لافراد المجتمع قصد التفييئ و بين التبجح بالانتماء إلى كتلة معينة و التسمي باسمها ، فالأول شيء علمي و الثاني حزبية مقيتة . أمثل لذلك بنفسي ؛ قد يصفني الواصفون بالسلفي و حق لهم ذلك إذا قصدوا التصنيف ، لكنني لا أرضى باسم غير اسم مسلم ، و لا أتكتل في كتلة غير كتلة المسلمين و جماعتهم .
إن حمل الإنسان لعقيدة أو فكر أو منهج معين شيء مباح مادام المحمول مباحا شرعا ، و قد يكون شيئا واجبا إذا كان المحمول واجبا شرعا ، أما تكتل الحاملين له و اجتماعهم تحت مسمى معين و اتباعهم لرجال معينين و جعل الولاء و البراء مبنيا على هذا التكتل فهو الأمر الحرام و إن سمي الحزب حزب الله .
العين في الإسلام
قال صلى الله عليه و سلم " العين حق " صحيح مسلم ، و قال سبحانه ( و أما بنعمة ربك فحدث ) ، قد يُشكل الأمر على بعض المسلمين لعدم قدرتهم على الجمع و الربط بين معنيي النصين باعتبار الجانب العملي ؛ أي يتيهون بين استحباب التحديث بالنعمة استجابة للأمر في الآية و بين كراهة التحديث بها استنادا على الحديث ، فيلجؤون إلى نص دون الآخر ، و غالبا ما يميلون إلى كراهة التحديث بالنعمة خوفا من العين تاركين العمل بالآية الكريمة لما يُتخيل لهم من خطر في تفعيلها مجتمعيا ، و هذا للأسف مما ابتلي به عامة الناس فقيرهم و غنيهم ، متعلمهم و جاهلهم ، ملتزمهم إن صح التعبير و غيره إلا من رحم ربي .
فبالعودة إلى النصوص الحديثية التي تكلمت عن العين نجدها تخاطب الناظر لا المنظور و لا متاع المنظور ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبنا قائلا " هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت " صححه الألباني ، و قد وردت هذه الصيغة و مثيلاتها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم دون أن يرد عنه عليه الصلاة و السلام خطابا ثابتا يدعو إلى ستر النعمة باستثناء ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الاستعانة بالكتمان عند قضاء الحوائج لا عند النعمة الحاصلة ( الستر مطلوب أثناء بذل الأسباب لتحقيق النعمة لا حين تحصيلها ) ، على ما في هذه الرواية من ضعف في الإسناد ، و إلا فإنه قال " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " حديث حسن ، و قوله " إن الله جميل يحب الجمال " رواه مسلم ، فالجانب العملي الوحيد الذي شُرع لنا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لمحاربة العين و أثرها في النعمة الحاصلة هو التبريك و ذكر الله عند رؤية ما يُعجب ، دون الممارسات غير الشرعية التي صرنا نراها اليوم من كذب و تصرفات صبيانية أحيانا قصد إخفاء النعم خوفا من العين .
ثم إن العين مهما بلغت من مبلغ أخاف الناس فإنها تضل دائما تحت قضاء الله و قدره ، فإنه لا يصيبك منها إلا ما قدّر الله لك ، و المؤمن يشكر في السراء و يصبر في الضراء و لا يجد بعدهما إلا الخير كما جاء في الحديث الثابت .
أمّا عقلا فإن هذا الأسلوب في الفرار من العين بستر النعم أسلوب لا عقلاني ، فحال صاحبه كالذي لا يخرج إلى الشارع خوفا من أن تصدمه سيارة ، أو لا يستعمل قنينة الغاز خوفا من الانفجار و الحريق ، أو لا يستعمل الكهرباء خوفا من السعق .
أخيرا عش حياتك بشكل طبيعي جدا ، دون ستر مبالغ فيه و لا افتضاح مذموم ، و ليس عليك إلا أن تبرّك عندما ترى ما يُعجبك سواء من نفسك أو من غيرك .
كروية أم مسطحة ؟
نجد الكثير من المسلمين يتصادمون على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأرض ، فريق يصفها بالكروية و يعتمد على الأدلة التجريبية ، و فريق يصفها بالمسطحة و يعتمد على الأدلة القرآنية ( زعما منه أنها تدل على التسطيح ) ، لكن ينبغي أولا تحديد المعنى المقصود من كلمة أرض في القرآن و العربية و في العلوم التجريبية .
معلوم أن القرآن و العربية يطلقان لفظ الأرض على الكل و مثاله ( السماوات و الأرض ) و على الجزء و مثاله ( أرض العرب ) و هكذا ، أما العلم التجريبي فيطلق لفظ الأرض على الكل فقط ( الكوكب ) دون الجزء ، فهذا الأخير تطلق عليه مصطلحات أخرى ( قارة ، يابسة ، جزيرة ، شبه الجزيرة... )
و بالتالي فإن وصف الأرض في كل آية قرآنية يكون إما باعتبار الكل أو باعتبار الجزء ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن القرآن الكريم يعتبر المرجعية ، أي أنه يصفها باعتبار مرجعية معينة .
أمثل للمرجعية بمثال حتى يتضح الأمر أكثر ، إذا قلت التفاحة تشبع كل فأر جائع ، فهذه جملة صحيحة معرفيا ، و إذا قلت التفاحة لا تشبع أي فيل جائع فهي أيضا جملة صحيحة ، و هذا لأن المرجع مختلف ، فالمرجع في الجملة الأولى هو الفأر ، أما في الجملة الثانية فهو الفيل ، و النتيجة هي جملتان صحيحتان معرفيا رغم حملهما لمعنيين متضادين و متضاربين ، و ذلك لاختلاف المرجع المعيار .
و بالتالي فإن عامل الكل و الجزء و عامل المرجع واجب استحضارهما لفهم الآيات المتكلمة عن شكل الأرض ، و سأترك عاملا ثالثا إلى آخر المقال .
الآيات التي يُستدل بها لإثبات أن الأرض كلها مسطحة منها ما يلي :
( وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ) [ الغاشية : 20 ]
يُستدل بهذه الآية الكريمة أن الأرض مسطحة ، لكن إذا رجعنا إلى الآيات التي تسبقها نجد قوله تعالى ( أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعت و إلى الجبال كيف نصبت و إلى الارض كيف سطحت ) ، و بالتالي فالمرجع هنا هو نظر الكفار خصوصا و نظر نوع البشر عموما ، فنحن من نراها قد سطحت ، كما نرى السماء قد رفعت ، و معلوم أن الله تعالى فوق السماء ، و بالتالي فإن المرجع هنا هو الإنسان و نظره ، ثم إن المقصود في الآية هو الجزء و ليس الكل ، و ذكره سبحانه للجبال قبل الأرض يبين أن المقصود بالأرض في هذه الآية الكريمة هو السهل و ليس جميع الأرض كما قد يتبادر لبعض الأذهان ، فالابل مستقلة عن السماء و السماء مستقلة عن الجبال و بالتالي فالأصل أن الجبال مستقلة عن الأرض هنا ، و ما جاء في القرآن من تسطيح للأرض يقصد به السهل و ليس جميع الأرض .
( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ) [ الحجر : 19 ]
ثم يُستدل بهذه الآية على تسطيح الأرض رغم أن اللفظ هو المدّ ، و معلوم أن الشيء الممدود هو الشيء بعيد الأطراف أو ما لا أطراف له و هذا كمال المد ، و هو ما لا يتحقق إلا في المجسم الكروي ، فهنا المقصود هو الكل و المرجع هو الله تعالى و ليس الإنسان ، لكن اللفظ لا يوجب التسطيح أبدا .
( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ) [ نوح : 19 ]
و هذه الآية مما يستدل به على تسطيح الأرض ، و مرة أخرى المرجع هنا الإنسان و يظهر ذلك في ( جعل لكم ) ، و بالتالي فهي لنا بساطا فعلا ، لكن هذا لا يدل على التسطيح أبدا .
( والأرض بعد ذلك دحاها ) [ النازعات : 30 ]
و دحاها بمعنى جعلها ممدودة واسعة و عظيمة ، فالدّحُوح وصف يطلق عند العرب على الشيء الممتد الواسع العريض و على المرأة العظيمة ، و معلوم أن امرأة عظيمة بمعنى عريضة و ليس بمعنى مسطحة ، و بالتالي كيف يكون اللفظ يدل على التسطيح !؟
أعزز قول أن كل هذه الأوصاف التي لم تتقيد بالإنسان كمرجع و التي تقصد الأرض ككل لا كجزء لا تدل على التسطيح بأن من يعتقدون أن الأرض مسطحة لا يقولون بالأرض الممهدة أو المدحوة أو الممدودة في مقابل الأرض الكروية ، و إنما المسطحة و هو اللفظ الذي جاء مقيدا بالمرجعية الإنسانية و بالجزئية لا الكلية كما سلف التبيان .
و هكذا هي كل النصوص التي يستدلون بها ، دلالاتها لفظية على الأرض ، غير قطعية على أنها مسطحة . بينما الدليل الذي يدل على كروية الأرض دلالته دلالة لزوم غير لفظية ، لكنها قطعية عقلا على أن الأرض كروية ، و الدليل كالتالي :
قال سبحانه (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) الزمر الآية (5) .
يُكَوِّرُ بمعنى يجعل الشيء كالكرة ، و ليس التكوير كالتدوير ، فالتكوير ثلاثي الأبعاد و منه كلمة كرة ، و التدوير ثنائي الأبعاد و منه كلمة دائرة . معلوم أن النهار هو الجزء المضيء من الأرض في لحظة معينة ، و الليل هو الجزء المظلم من الأرض في لحظة معينة ، و بما أنهما يتكوران على بعضهما فإن دلالة كروية الأرض لازمة من الآية لا غبار عليها .
أشير هنا أن السلف الذين قالوا بتسطيح الأرض معذورون و ذلك راجع للعامل الثالث الذي سيأتي ذكره ، لكن غير المعذور هو من يتشبث باجتهاد العالم كما يتشبث بالقرآن ، و يؤول النص الشرعي لكي يتطابق مع فهم العالم بعلة لزوم فهم السلف ، و هذا من الخطإ ، فلزوم فهم السلف واجب في نصوص و أولى في أخرى و ليس بأولى في نصوص أخرى و منها التي جُعلت لإقامة الحجة على كفار في زمن غير زمن الصحابة ، و هذا يحتاج إلى مقال مستقل سيأتي إن شاء الله .
العامل الثالث الذي ينبغي اعتباره عند مثل هذه الآيات هو عامل التورية العلمية في القرآن إن صح التعبير ( و التورية هي التكلم بكلام صادق يحتمل معنيين أو أكثر ، و يكون المقصود منه ليس المعنى الظاهر و إنما المعنى الأقل ظهورا لسبب من الأسباب ، و لا يجوز الحلف على أساسه بخلاف ما تفعل العامة لأن القسم يعتبر فهم المخاطَب لا لفظ المخاطِب ) فمعلوم أن الله تعالى شرّع شرائع بشكل مباشر دون تدرج ، و شرّع أخرى بتدرج مثل التدرج في تحريم الخمر ، و من علل ذلك أنه سبحانه لطف بالمسلمين لأنهم اعتادوها و يصعب التخلص من إدمانها في لحظة ، كذلك أمر العلم ، فالتصريح بكروية الأرض لأناس أميين يرون الأرض مسطحة سينتج الارتباك و الأثر السلبي على عقول حديثي العهد بالشرك ، و من لطفه تعالى جعل الآية تدل على الكروية بأسلوب دلالة اللزوم لا بدلالة اللفظ ، و من نفس المنهج قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : "حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يُكذَّب اللهُ ورسولهُ؟". صحيح البخاري ، فالمنهج الإسلامي في هذا هو تعليم كل متعلم على قدر إمكانياته ، لأن الأساس الأولي هو ثبوت الإيمان .
ثم إن أهم أسباب تكلم الله تعالى بهذا الكلام هو السبب المذكور في قوله تعالى ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) (53) الله تعالى شاء أن يظهر للكفار آياته ( الكونية و القرآنية ) في الآفاق و في البشرية لكي يتبين لهم أنه الحق سبحانه و لتقام عليهم الحجة البالغة ، و ربما تدخل هذه الآية العظيمة في هذا الباب . و الله تعالى أعلى و أعلم .
تجديد الدين
جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا" صححه الألباني وغيره .
و بالتالي فإن مفهوم تجديد الدين متفق على حقيقته بالإجماع ، ولكنه من أكثر أمور الدين اختلافا في فهمه و تأويله بين الفرق و المذاهب .
اختلف الناس في مفهوم تجديد الدين اختلافا كبيرا ، وذهبت كل طائفة إلى ما يوافق فهمها أحيانا وهواها أحيانا أكثر لما في ذلك من جلب للمصالح الاقتصادية أحيانا و الاجتماعية أحيانا أخرى . وسنستهدف في هذا المقال أهل الإفراط و أهل التفريط في هذا الباب ، و نبين خصائص أهل التوسط و الاعتدال فيه .
أهل الإفراط في التجديد : أفرط الغلاة المنعوثين في عصرنا بالمتنورين في باب التجديد إفراطا مخلا بعين الدين و أصوله ، وهم في حقيقة الأمر مزورين و مغيرين وليسوا بمجددين ، حيث اعتبروا أن التجديد هو ذوبان شرائع الدين و فقهه في قالب العالم الرأسمالي ، فيكون القانون العالمي مرجعا و الدين مهرولا إلى مسايرته في أموره كلها ، حتى رأينا من ينسب إلى الدين يشرعن الشذوذ الجنسي و الزنى و الخمر و غيرها من الموبقات المجمع على حرمتها ، بل بلغ الأمر من بعضهم اللعب في المعتقدات مما قد يُخرج صاحبه من دائرة الدين بالكلية .
كثير من هؤلاء المتنورين بنور الضلال لهم أطماع اقتصادية واجتماعية تدفعهم إلى هذا ، فتكون المصلحة الشخصية هي محركهم الأساسي ، وبعضهم تبنى الفكرة و السواد الأعظم منهم جمع بين الشرين ؛ ضلال منين و بيع للدين مقابل دنيا .
هؤلاء معلوم أمرهم عند أغلب المسلمين ، فهم لا يعتمدون على الإقناع بقدر ما يعتمدون على التكرار و اللعب في لاوعي المتلقي الذي يريدون منه أن يطبع أولا ثم يتبنى ثانيا بعد طغيان الفكرة في الإعلام بشتى أنواعه .
أهل التفريط في التجديد : وهم طوائف و مذاهب أبرزهم توجهين ؛ الأقدم أهل الغلو و التعصب المذهبي ، الذين يرفعون قول أئمتهم عاليا جدا ، أحيانا فوق الحق و الصواب الظاهر و أحيانا أخرى فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم ، بل و فوق قول رب النبي سبحانه وتعالى عياذا بالله . و هذا في أصله ظاهرة نفسية (فخر الانتماء و التعصب) يميل لها البشر في شتى المجالات ، لكن الوقوع فيها فقهيا و دينيا مذموم جدا .
حيث يسقط متعصبوا المذاهب الفقهية في تقديس النص الفقهي للإمام و جعله مرجعا مطلقا يرد مخالفه و لو جاء باجتهاد أفضل و دليل أقوى ، فيعتبرون المجتهد الذي جاء بالدليل الصحيح الصريح في المسألة غير مؤهل لمخالفة الإمام و إن جاء بالحق الساطع . و هنا تم إغلاق باب الاجتهاد الفقهي من طرف هؤلاء. وليس كل المتمذهبين متعصبين و جامدين ، و لكن الذين تعصبوا منهم أثّروا سلبا على تطور الفقه في التاريخ.
و أحدث هذه الطوائف هي السلفية المعاصرة . سقطت السلفية و أصحابها في فخ منطقي كبير ، جعلها تبنى على مغالطة فكرية أثرت على جميع العالم الإسلامي.
نعم إن للسلفية فضل في تشبث المسلمين بسنة نبيهم صلى الله عليه و سلم، و نعم إن السلفية ظهرت بنيّة التمسك بالحق و تجنب الضلال، لكن ليس كل ما نقصده نحققه ، فالسلفية حرفت معنى الاقتداء بالسلف ، وجعلوا قول السلف ملزما كما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن لم يكن بنفس الدرجة ، و أقلهم خطأ الذين أخذوا بقول الإمام مالك المشهور : كل يؤخذ من قوله و يرد إلا صاحب هذا القبر ، أي النبي صلى الله عليه و سلم . لكن، ألزموا الآخذ بالأخذ عن أحدهم فيما اجتهدوا فيه لزوما و لم يجيزوا الاجتهاد هنا للفقهاء، و هذا في الحقيقة هو مذهب الحنابلة في المسألة دون غيرهم من المذاهب، فالسلفية و إن ادعت استقلاليتها عن المذاهب فارتباطها بالحنبلي معلوم عند أهل الفقه و الحديث و التاريخ ، بل هي في حقيقة الأمر امتداد للحنابلة و ليس الإشكال هنا .
الإشكال عند السلفية في تعريفها ، فيعرفون السلفية ب (الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة) و يستندون على خيرية السلف الثابتة في الحديث على هذا التعريف الغلط، فيقولون؛ بما أن خير القرون هي الثلاثة الأولى على التوالي فإن قولهم الفقهي نعتبره دليلا ونتبعه، وهنا وقع الإشكال، فاتباع السلف المطلوب في الحديث هو اتباع طريقتهم في استخراج الأحكام الفقهية من الأدلة كما كانوا يفعلون و اتباعهم في التقوى و العمل الصالح و ليس اتباع قولهم و اجتهادهم، ولا أقصد هنا العقائد أو العبادات الشعائرية، فمرد هذه الأخيرة الكتاب و السنة، و إنما القصد الفقه الذي يترتب عليه العمل، فهذا يجتهد فيه المجتهدون في أي زمان و مكان بشرط أن يكون المجتهد من أهل الزمان و المكان، ولا يقتصر على فئة دون أخرى عند توفر ظروف و شروط الاجتهاد.
فاتباع سلف الأمة هو أن نعمل مثلهم ، عمل صالح كعملهم الصالح، و اجتهاد منضبط كاجتهادهم، و ليس لزوم قولهم.
النصوص الملزمة هي الكتاب و السنة الثابتة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة لوجوب اتباعهم كما جاء في الحديث ، وما عداهم من الصحابة فمجتهدون نأخذ بقول أحدهم أو بقول أحد المعاصرين من المجتهدين في المسألة ولا حرج في ذلك، و التابعون في هذا من باب أولى، إنما الحرج و الغلط في الأخذ بالباطل أو الخطإ أو المرجوح و ترك الحق و الصواب و الراجح بغض النظر عن صاحبه.
الاجتهاد بلزوم ضوابطه أمره عظيم جدا، و يجب عدم التضييق عليه بالتقليد، و التجديد في أمور الدين هو اجتهاد مضبوط قواعدا في مسائل الدين المستجدة في المجتمع أو القديمة على حد سواء، ولا نحرف لفظ التجديد في الحديث بمصطلح إحياء السنة، فإحياء السنة أمر واجب على كل مسلم لكنه ليس هو المقصود في حديث التجديد.
كما أشير إلى أن علوما أخرى كعلم التفسير قد تعرضت لنفس الأمر من تقليد و تعصب، فنحن اليوم نرى من يتشبث بتسطيح الأرض في التفسير لأنه قول بعض السلف و يتجاهلون أقوال المفسرين بعدهم رغم انضباط تفسرهم أكثر لقواعد التفسير و اللغة. فجعلوا عوام المسلمين في حيرة شديدة بين اتباع قول السلف في المسألة أو تقرير الواقع، وليس هذا من الدين البتة. أما من كان مهتما بشكل الأرض في النصوص القرآنية فإن فكروسكوبي قد تعرض لهذا مقالا و مرئية.
و الله تعالى أعلى و أعلم.
و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها حين يمسي، فمات من ليلته؛ دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح، فمات من يومه؛ دخل الجنة " صحيح البخاري .
بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفارا يغفر الله تعالى به ذنوب المسلمين و يدخلهم الجنة إن استغفروا الله بذكره في صباحهم أو مساءهم ، و هو الذي بين أيديكم و الذي أُطلق عليه اسم سيد الاستغفار ، و كفى به وصفا لعظمة شأنه .
اعتاد أغلب المسلمين هذا الدعاء العظيم في صلاتهم ، و قد يكررونه لعشرات المرات في يومهم ، و هو أمر محمود جدا و مبشر لهم بالجنة إن لزموه ، لكن أغلب الداعين بهذا الدعاء يغلطون في فهم جزء منه بسبب احتمال اللغة فيه لمعاني مختلفة ، و هذا راجع إلى تقصير في دراسة العقيدة الإسلامية الواجبة عينا ، و هي سهلة ميسرة للعموم ، و لا أقصد هنا أصول الاعتقاد التي تجب على طلبة العلم الشرعي دون غيرهم ، فهذه الأخيرة فرض كفاية و ننهى العامة عن الخوض فيها ، فهي إنما خيض فيها لدفع شبه أهل الضلال الفكري و العقدي و ليس لذاتها .
أما الغلط في الفهم فيتعلق ب"و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت"
و معلوم في اللغة أن ما تحتمل معاني متعددة ، و ما هنا جاءت تحتمل معنيين ظاهرين :
الأول :و أنا على عهدك يا الله و وعدك لم أستطع .
الثاني :و أنا على عهدك يا الله و وعدك ما دمت مستطيعا .
و المعنى المقصود في الدعاء و الصحيح عقيدة هو المعنى الثاني الذي جاءت فيه "ما" شرطية تربط لزوم العهد بالاستطاعة ، و أدلة ذلك من الكتاب و السنة متواترة المعنى نذكر منها :
قول الله سبحانه (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) البقرة(286)
قول الله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة(173)
قول ربي جل جلاله (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) الأنعام(119)
كذلك القاعدة الفقهية المعتمدة المستنبطة من النصوص الشرعية ؛ "الضرورات تبيح المحذورات" .
أما فهم "ما" في الدعاء كحرف نفي فهو غلط عقدي لا ينبغي اعتقاده ، فالمسلم لا يستسلم لأمر عدم القدرة على الوفاء بعهد الله المقدور عليه و الذي هو في الاستطاعة ، و إنما يفي و يسقط لبشريته في ذنوب فينهض و يتوب و يستغفر و يلزم عهد الله سبحانه مادام فيما يستطيعه و يقدر عليه ، وقد يذنب مرة أخرى فيتوب و يصلح مرة أخرى ولا مجال للاستسلام ، إنما هي حرب مع الشيطان إلى أن نلقى الله وهو عنا راض إن شاء الله نعترف له سبحانه بضعفنا و احتياجنا إليه جل جلاله ، ولا يحاسبنا الرحمن على ما لا طاقة لنا به ، فلا إثم على شارب الخمر المضطر خوفا من الموت عطشا ، و لا على المقترض ربا للعملية الجراحية لولده خوف هلاكه بعدما لم يجد له مقرضا محسنا ، ولا على عدم إتيان ركن الحج للفقير .
فالوفاء بالعهد واجب اللزوم لقول ربي الكريم (أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) (21) سورة الرعد .
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ليس بمعنى الذين لا يسقطون في الذنب فهذا محال إلا لأهل العصمة من الأنبياء ، و إنما الذين يلزمون الدين و ينهضون بعد السقوط فيتوبون و يحاربون الوسواس الخناس باللجوء إلى رب الناس.
وجهَي غزة
إن لألم غزة وجهان مختلفان و متضادان ؛
الأول نراه جميعا من قصف و تدمير و تجويع و إبادة و غيرها ، و هو أمر شنيع يُدمي القلوب و يذرف العيون و يُعجز الجوارح و يكسر الخواطر ، كيف لنا أن نستسيغ ظلم 10 ملايين يهودي صهيوني لمليوني مسلم بقطاع غزة علما أن عدد المسلمين بالأرض حوالي المليارين و اليهود لا يتجاوز عددهم على الأرض 20 مليونا ، ورغم ما في هذا من الذل و الهوان إلا أنه واحد من آلاف البراهين على صحة النبوة ؛ فعلا نحن اليوم غثاء كغثاء السيل .
أما وزرنا فحدث ولا حرج ، إن الدفع و رفع الضرر عن مسلمي غزة فواجب شرعي كفائي ، أي إذا قامت به فئة سقط الوجوب عن باقي الفات ، أما إذا لم يقم به أحد فالوزر ثابت على الجميع كل حسب قدرته في الدفع. و اليوم نرى أغلبية المسلمين لا يقومون بما عليهم كما يجب ، فمنا من لا يجعل للغزاويين دعاء عند الصلاة ، و منا من لا يقاوم بالمقاطعة ، و منا من لا يغير نمط حياته ولو جزئيا بترك المبالغ فيه من الاستمتاع بمتاع الدنيا الفاني ، فلا يُظهر ولو جزء صغيرا من الاهتمام ، و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم حاسم في هذا الباب ؛ من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم . أشير هنا أن هناك من الشعوب المسلمة التي نُكّل بها أشد تنكيل دون ترويج إعلامي لمعاناتهم ، و لهم منا نفس الحق و إن اختلفت لغاتهم و أعراقهم عنا ، فلا فرق بين أسود ولا أبيض ولا غيرهما من الألوان البشرية إلا بالتقوى، و الإسلام جامع لكل الأجناس.
أما الوجه الثاني لمعاناة غزة فعكس هذا تماما ، و هو ألم و انكسار و حسرة لا يدركها إلا العلماء و طلاب العلم و الواعون من العوام ، إنما الاخرة هي الحيوان ، و الحيوان صيغة مبالغة لكلمة الحياة ، أي أنها الحياة الحقيقية و الخالدة . فبمقياس النوع و مقياس الزمن نُدرك أن ما نعيشه اليوم ليس العيشة الأفضل من حيث النوع و لا من حيث الزمن ؛ دُنيا مقارنة بالآخرة كالحلم مقارنة باليقظة ، و عمرها مقارنة بعمر الآخرة كالصفر مقارنة بالأبد . ثم نفرح بالصفر و الأبد نهلكه بالخذلان لأهل غزة ، و نفرح بالوهم و الحقيقة نهلكها بتسليمهم للصهيون ، بيس ما نزرع و بيس ما سنحصد إلا برحمة من الرحمن الرحيم.
أما عن معاناة أهل غزة فهي اليوم دمار و عند الاستشهاد عمار ؛ فالله يغمسهم في النعيم غمسة يقولون بعدها ما رأينا عذابا و لا هما و لا ضنكا و لا حاجة قط ، بل حتى استشهاد أغلبهم يكون في لحظة أقصر من الثانية زمنا ؛ بألمها و حسرتها لخذلاننا ، فيرتقون و نؤزر ، و يفوزون و نخسر إلا برحمة من الله الرحمن الرحيم .
و هم أحياء عند ربهم يرزقون ؛ ويا له من كرم و عطاء . تخيل أن تعيش بأرض قاصية مبايعا لملك أنت و إخوانك و أهل بلدتك ، ثم يستدعي الملك أخاك ليعيش عنده بقصره باقي حياته متنعما دون أن تتمكن من لقياه و معرفة أخباره ، بينما يعرف أخوك أخبارك بما يُعلمه الملك عنك . و لله المثل الأعلى و القياس الأولى ؛ فاعلم أنه ليس عند الملك ؛ بل عند الرب ملك الملوك ، و ما أدراك ما غبطتك له يا من تدري أنه منعم بينما تعيش أنت بين المراحيض و الأمراض و الحاجة و الجوع و الهم و غيرها من لوازم الحياة الدنيا . ثم أنت تُسأل عند الله عن خذلانك لهم ، أأدركت الان كيف اصطفاهم الله أم لم تدرك!
إن غزة واحدة ، ووجها عملتها اثنان . تمعن في الأول لتعلم قدر نعمة الله عليك ، و تمعن في الثاني لتعلم قدر كرم الله لهم . اللهم اقبلنا عندك برحمتك يا أرحم الراحمين.